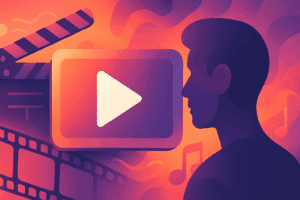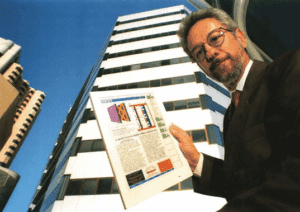كان سقراط يقول:
«تكلّم حتى أراك»
أما نحن، في عصر الميكروفونات المفتوحة، فنحتاج أن نهمس حتى لا نضيع بين الأصوات.
الكلّ يتحدث الآن، لكنّ القليل فقط يُسمَع. وبين منشورٍ يُكتب كل ثانية، وفكرةٍ تموت قبل أن تُقرأ، يبدو أن “المحتوى” أصبح ضحيةً لشهرته.
البداية… حين كان الصمتُ أبلغ
منقوشات الكهوف الأولى لم تكن تبحث عن "إعجابات"، بل عن أثر.
الفرعونيّ الذي حفر قصة انتصاره على الحجر لم يكن يتخيّل “تفاعلًا”، لكنه أراد أن يُقال يومًا: لقد كان هنا.
منذ ذلك الحين تغيّر كل شيء تقريبًا… إلا الدافع ذاته.
ما زال الإنسان يريد أن يُسمع.
الفرق الوحيد أن الضجيج ازداد، والجوهر قلّ.
المحتوى لا يعيش على الأضواء وحدها
الإبداع اليوم يُقاس بحجم الوصول أكثر مما يُقاس بأصالة الفكرة، واستنساخ الأفكار يبهر العاميّ لبساطة استيعابها.
لكنّ ما يُدهش في اللحظة لا يعيش طويلًا.
الخطابات التي غيّرت الوعي لم تكن مصقولة بأدوات التصميم، بل مشحونة بفكر أصحابها.
فدوستويفسكي، مثلًا، لم يكتب من مكتب فخم أو مقهى هادئ، بل من دهاليز ومطابع رخيصة ورأسٍ مزدحم بالأسئلة.
كان يكتب ليبقى، لا ليُدهش أحدًا.
وربما لهذا السبب، بقت كلماته بعد أن غاب، لأن ما يُكتب للنجاة لا يشيخ.
وفي الجهة الأخرى، هناك كافكا… الرجل الذي كتب بسكون لدرجة أنه لم يسمع نفسه.
ترك أوراقه لتُحرق، لكنها اشتعلت بطريقةٍ أخرى.
كلماته التي لم يرد لها أن ترى النور أصبحت تُقرأ بكل اللغات، كأن العالم اعتذر له متأخرًا.
ربما كان ذلك إنصافًا أدبيًا من التاريخ، أو مجرد عبثٍ آخر يشبهه.
الفكرة الصادقة حين تُقال ببساطة تكفي لتغلب ضجيج العالم كله.
لكننا – أحيانًا – نكتب لنبدو نبهاء، لا لنُفهم.
الجمهور لا يريد دروسًا… يريد مرآة
الناس لا تبحث عن كاتبٍ يقول لهم ماذا يفعلون، بل عن أحدٍ يشبههم حين لا يكونون بخير.
لهذا ينجح المحتوى الإنساني وإن كان بسيطًا، لأنه لا يُعلّم بقدر ما يُواسي.
كل منشور جيد يشبه جلسة صديقٍ لا يُلقي النصائح، بل يشاركك فوضى الحياة، ويتركك بعدها أخفّ قليلًا.
فالبشر، مهما ادّعوا القوة والاستقلالية، لا يحبّون أن يتألموا وحدهم.
نحن نبحث عن الاعتراف، عن المشاركة؛ عن شخصٍ يقول: أنا أيضًا شعرت بذلك، أكثر من خبير يعلمنا كيف الحياة.
حتى أكثر الناس عزلةً يحملون رغبةً خفيّة بأن يُفهَموا، أو على الأقل ألّا يُترَكوا وحدهم في الظلام.
التميّز الذي نتغنّى به غالبًا ليس رغبةً في الاختلاف، بل محاولة أن نجعل وجعنا مميزًا بما يكفي كي لا يُنسى.
ولهذا، حين يلمسنا محتوى صادق، لا ننجذب إليه لفصاحته، بل لأننا نرى فيه ظلّنا، ويشعرنا بالانتماء والترابط.
خرافة اسمها الخوارزمية
الخوارزمية؟
هي ذريعة مريحة نبرر بها خواء النص، وكبش نذبحه فداءً لضياع ما كُتِب في فضاء الشبكات.
وهي في الحقيقة، تُظهر لنا ما نستهلكه أكثر، تمامًا كمرآة بلا حياد.
ربما ليست هي من تغيّر ذوق الجمهور… بل نحن من غيّرنا ذوقنا لتناسبها.
وتتكرر الأسئلة:
أيهم يقرر ما يُنشر، الكاتب أم القارئ؟
ربما لم يعد حكرًا على أي منهما.
هل أصبح الكاتب يكتب إرضاءً للخوارزمية، أم يكتب لينثر أفكاره، أم يكتب ليثير إعجاب القارئ؟
ولأن القارئ اليوم لا يرى إلا ما تمليه عليه الخوارزمية، أأصبح محاطًا بفقاعة ترشيح "تحميه" من المعرفة؟
ربما السؤال اليوم ليس "من يقرر؟"
بل "من يجيد لعبة اللوغاريتمات والخوارزميات؟"
فخواء المحتوى قد لا يكون اختيارًا، بل لأن التيارات البرمجية لا تَهدينا إلا للزَبَد، ولا عدةٌ للغوص نراها لنستخرج اللؤلؤ.
ما يبقى بعد انطفاء الأضواء
بعد أن تمرّ العناوين، وتُمحى المنشورات، ويُغلق التطبيق، يبقى سؤال بسيط:
هل كان فيما كتبناه شيء يستحق أن يُتذكّر؟
في النهاية، لا أحد يعرف أيّ الكلمات ستبقى، ولا أيّها سيتبخر مع إشعارٍ جديد.
كل ما نفعله أننا نصرخ بملء حناجرنا…
ونأمل أن نجد من يرد علينا صوتنا ولو همسًا.